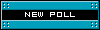| thesilentlover1 | التاريخ: الأحد, 2012-04-01, 0:42 AM | رسالة # 1 |
 القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 312
حالة: Offline
|
عوارض أحوال متعلقات الفعل
وهي المفاعيل؛ والظروف؛ والمجرورات؛ والحال، والتمييز، وأهم ما يتعلق به غرض البليغ هو أحوال المفاعيل وخاصة المفعول به فإنه الذي تعرض له أحكام الحذف دون غيره من المفاعيل لأنه إذا لم يذكر علمنا أنه محذوف إذ الفعل المتعدي يطلب مفعوله طلبا ذاتيا ناشئا عن وضع معنى الفعل المتعدي فإن الفعل اللازم وضع ليدل على حدث صادر من ذات واحدة والفعل المتعدي وضع ليدل على حدث صادر من ذات ومتعلق بأخرى. أما بقية المفاعيل فإنها إذا لم تذكر لا يوجد دليل يدل على أن المتكلم قصد ذكرها () ثم حذفها وكذلك أحكام التقديم إنما تغلب مراعاتها في المفعول به.
فإذا لم يذكر المفعول به مع فعله المتعدي إليه ولم تكن قرينة على تقديره فحذفه حينئذ قد يكون لإظهار أن لا غرض بتعليق ذلك الفعل بمفعوله فينزل الفعل حينئذ منزلة اللازم بحيث يكون النطق به ليس إلا لقصد الدلالة على أصل معناه الحدثي إذا لم يجد المتكلم فعلا آخر يدل على ذلك المعنى أو لم يستحضره فحينئذ لا يقدر لذلك الفعل مفعول نحو ((هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون)) وقول البحتري يمدح المعتز بالله العباسي
شجو حساده وغيض عداه
أن يرى مبصر ويسمع واعي
فلم يذكر مفعول يرى ويسمع لأنه أراد أن يوجد راء وسامع فلا غرض لمعرفة مفعول. والمعنى أن الرأي لا يرى إلا آثار الخليفة الحسنى والسامع لا يسمع إلا ثناءه. وقرينة ذلك قوله شجو حساده.لأن ذلك هو الذي يشجو حساده ويغيض عداه وقد يكون الحذف لقصد التعميم مثل(( والله يدعو إلى دار السلام)) أي يدعو كل أحد وإنما قلنا آنفا(( ولم تقم قرينة على تقديره)) لأنه إن كان المفعول مقدار منوي اللفظ فهو كالمذكور والقرينة أما من نفس الفعل بأن يكون مفعوله معينا لأنه لا يتعدى إلا إليه كقول عمرو بن معد يكرب
فلو أن قومي انطقتني رماحهم
نطقن ولكن الرماح أحبرت
فإن فعل أجر معناه شق اللسان فمفعوله متعين.وإما بأن يكون عليه قرينة لفظية وهو كثير.
وأما تقديم المفعول وما معناه كالجار والمجرور والظرف فقد يكون للحصر نحو(( إياك نعبد)) وفي الحديث الصحيح(( ففيهما فجاهد)) يعني الأبوين() وهو كثير في كلامهم. وقد يكون لمجرد الاهتمام نحو(( وأما ثمود فهديناهم)) في قراءة النصب وقد يكون لغرض لفظي كالسجع والفاصلة في نحو(( ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه)).
القصر()
القصر تخصيص حكم بمحكوم عليه بحيث لا يثبت ذلك الحكم لغير ذلك المحكوم عليه. أو تخصيص محكوم عليه بحكم بحيث لا يتصف ذلك المحكوم عليه بغير ذلك الحكم بواسطة طريقة مختصرة تفيد التخصيص قصدا للإيجار فخرج بقولنا بواسطة طريقة مختصرة إلخ نحو قول السموأل
تسيل على حد الظبات نفوسنا
وليست على غير الظبات تسيل
فإن هذا المثال اقتضى تخصيص سيلان النفوس أي الدماء بالكون على حد الظبات لكن ذلك ليس مدلولا بطريقة مختصرة بل بجملتي إثبات ونفي.
والمراد بالحكم والمحكوم عليه الأمر المقصود قصره أو القصر عليه سواء كان أحد ركني الإسناد نحو(( ما محمد إلا رسول الله )) أم كان متعلق أحدهما كالمجرور المتعلق بالمسند في قول كعب بن زهير
لا يقع الطعن إلا في نحورهم
وما لهم عن حياض الموت تهليل
فقصر وقوع الطعن على الكون في نحورهم وكالحال المخصصة للمسند إليه نحو: إنما الشاعر زهير راغبا. إذا أردت قصرا أدعائيا في حالته هذه( لقولهم: زهير إذا رغب،والنابغة إذا رهب، والأعشى إذا طرب، وعنترة إذا ركب).
وكالظروف في قول عمر بن أبي ربيعة
فقالت وألقت جانب الستر إنما
معي فتحدث غير ذي رقبة أهلي
أي إنك لا تتحدث الآن إلا معي فقل ما شئت. فالمخصوص بشيء يسمى مقصورا والمخصوص به شيء يسمى مقصورا عليه والمقصور هو الذي لا يتجاوز المقصور عليه لغيره والمقصور عليه هو الذي لا يشاركه غيره في الشيء المقصور. فالاختصاص والحصر مترادفان.
والقصر إما القصر موصوف على صفة بمعنى أن لا يتجاوز الموصوف تلك الصفة إلى صفة أخرى. وأما القصر صفة على موصوف والمراد بالصفة والموصوف هنا الحكم والمحكوم عليه لا الصفة المعروفة في النحو.
وطرق القصر ستة وهي: النفي مع الاستثناء، وإنما ، والتقديم، لما لحقه التأخير من مسند ومفعول ومعمول فعل. والعطف بلا وبل ولكن. أو ما يقوم مقام العطف من الدلالة على الاستدراك لإثبات بعد نفي أو عكسه. وتعريف المسند. وتوسيط ضمير الفعل. وهذه أمثلتها على الترتيب: قول لبيد
وأما المرء إلا كالشهاب() وضوئه
يحور رمادا بعد إذ هو ساطع
وقوله تعالى(( إنما حرم عليكم الميتة)) . وقوله تعالى (( لكم دينكم ولي دين)) وقوله تعالى(( إياك نعبد وإياك نستعين)) وفي ذلك(( فليتنافس المتنافسون)) .
ومثال طريق العطف بلكن بعد الواو قوله تعالى(( ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما)) وكذا قوله تعالى(( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله)) فهو قصر بعد قصر لأن قوله (( إلا من أكره)) أخرج المكره من الكافر ثم أخرج منه من شرح بالكفر صدرا فالتقدير من كفر بالله مكرها لا غضب عليه ولكن من شرح بالكفر صدرا. وأعلم أن هذه الآية فيها ثلاثة طرق من طرق القصر. ومثال العطف بلا(( اللهم حوالينا ولا علينا)) فالواو زائدة والمعنى لا تنزل المطر إلا حوالينا.
وأما طريق تعريف المسند فأعلم أن التعريف الذي يفيد القصر هو التعريف بلام الجنس فإذا عرف المسند بها أفاد قصر الجنس على المسند إليه نحو(( أنت الحبيب)) قصر تحقيق و ((هو العدو)) قصر إدعاء(( والحزم سوء الظن بالناس)) قصر قلب (( إن شانئك هو الأبتر)) كذلك.
وإما توسيط ضمير الفصل فنحو(( ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عبادة)) ونحو(( كنت أنت الرقيب عليهم)) و(( أن ترن أنا أقل منك مالا وولدا)) وضمير الفصل هو ضمير يتقدم على الخبر ونحوه. ولا يفيد أكثر مما أفادته النسبة لعدم الحاجة إليه في ربط.
وأعلم أن طريق النفي والاستثناء وإنما والعطف بلا وبل ولكن؛ متعينة للقصر. وإما التقديم وتعريف المسند والفصل فقد تكون للقصر وقد تكون لغيره ولكن الغالب كونها للقصر فيستدل عليه منها بمعونة القرائن في المقام الخطابي.
والقصر نوعان حقيقي واضحي لأن التخصيص لشيء إن كان مبنيا على أنع كذلك في الواقع ونفس الأمر فهو القصر الحقيقي. وإن كان مبنيا على النظر لشيء آخر يقابل الشيء المخصص به فقط لإبطال دخول ذلك المقابل فهو قصر إضافي تدل عليه القرينة. فالأول كقولك إنما الخليفة فلان. الثاني كقولك إنما الكاتب زيد أي إلا عمرو ردا على من زعم أن عمرا كاتب ولا تريد أن زيد هو الكاتب في الأرض أو في البلد دون غيره والحزم سوء الظن بالناس أي ليس حسن الظن بحزم ولم يرد أن الحزم كله في سوء الظن. ومن القصر الحقيقي ما يسمى بالادعاءي وهو أن تدعي قصر الصفة على الموصوف لقصد المبالغة نحو قوله تعالى(( أن يدعون من دونه إلا إناثا)) مع أنهم دعوا هبل ويغوث ويعوق لكنهم لما أكثروا دعوة اللت والعزى ومناة جعلوا كالذي لا يدعو إلا إناثا. وقوله في حق المنافقين(( هم العدو فاحذرهم)) مع أن المتظاهرين بالشرك والكفر أعداء لكن لما كانت مضرة عداوة المنافقين أشد جعلت عداوة غيرهم كلا عداوة.
الإنشاء
الكلام كله إما خبر أو إنشاء. فالخبر هو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب بأن يكون للنسبة المعنوية التي تضمنها الكلام خارج أي وجود في نفس الأمر يوافقها تارة ولا يوافقها أخرى. فإن وافقها الخارج فهي صادقة وإن خالفها فهي كاذبة لأن الخبر يقصد منه حكاية ما في الوجود الخارجي فلا جرم لزم عرض نسبته على ما في الخارج. فإن نشأ عن ذلك العرض علم بأنها مطابقة بل هي مخالفة للخارج فهي كاذبة.
والإنشاء الكلام الذي ل يحتمل الصدق والكذب لأنه لم يقصد منه حكاية ما في الخارج بل هو كاسمه أحداث معنى بالكلام لم يكن حادثا من قبل في قصد المتكلم. وكل ما تقدم من الأحكام في الأبواب الماضية يجري في الخبر والإنشاء فلا غرض لذكر باب يخص الإنشاء هنا إلا للتنبيه على الفرق بينه وبين الخبر وللإشارة إلى أحكام قليلة بلاغية تختص بالإنشاء.
ينقسم الإنشاء إلى قسمين طلبي وغير طلبي. فالطلبي هو الأمر، والنهي،والاستفهام، والتمني، والترجي، والنداء. وغير الطلبي. القسم، والتعجب، وإنشاء المدح والذم نحو نعم وبئس. وإنشاء الوجدانيات كالتحسر والفرح والترحم. وصيغ العقود نحو أبيع وأشهد. والأجوبة الدالة على الامتثال كجواب النداء نحو لبيك وسمعا وطاعة. وصيغها وأدواتها وأحكامها مقررة في النحو. وإنما الذي يهم البليغ من أحوال الإنشاء مسائل:
الأولى- قد يأتي الإنشاء في صورة الخبر وهو ما يعبرون عنه بالخبر المستعمل في الإنشاء مثل استعماله في الدعاء في نحو(( رحمه الله)) . وفي الطلب نحو قول الظمئان إني عطشان. والتحسر نحو قول جعفر بن علبة الحارثي
هواي مع الركب اليمانين مصعد
جنيب وجثماني بمكة موثق
والسؤال نحو(( رب لما أنزلت إلي من خير فقير)) .
الثانية- يستعمل بعض صيغ الإنشاء في بعض فيجيء الأمر للتمني نحو قول امرئ القيس
ألا أيها الليل الطويل ألا انجل
بصبح وما الإصباح منك بأمثل
فقوله انجل تمن. وللتعجب نحو قوله تعالى(( انظر كيف ضربوا لك الأمثال)) ويجيء الاستفهام للنهي نحو((اتخشوهم فالله أحق أن تخشوه)) . وللأمر نحو(( فهل أنتم منتهون)). وللتعجب نحو(( وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام)) .
ويجيء النداء للتعجب في باب الاستغاثة نحو قول امرئ القيس
فيا لك من ليل كأن نجومه
بكل مغار الفتل شدت بيذبل
(تنبيه) هذه الاستعمالات المذكورة في المسألتين من قبيل المجاز المركب المرسل. والعلاقة العامة في جميعها هي اللزوم ولو بعيدا. وقد تتطلب لبعض استعمالاته علاقات أخرى بحسب المواقع.
المسألة الثالثة- قد تستعمل صيغ الإنشاء في من حاله غير حال من يساق إليه ذلك الإنشاء كأمر المتلبس بفعل بأن يفعله نحو(( يا أيها الذين آمنوا)) . وكنهي من لم يتصف بفعل عن أن يفعله نحو(( ولا تحسبن لله غافلا عما يعمل الظالمون)).
والقصد من ذلك طلب الدوام. فينزل المتصف منزلة غير المتصف تحريضا على الدوام على الاتصاف. وكنداء المقبل عليك نحو قولك للسامع يا هذا. ونداء من لا ينادى بتنزيله منزلة من ينادى نحو(( يا حسرة على العباد)) أي احضري فهذا موضعك. وهذه مجازات ظاهرة وتفريعها سهل.
هذا نهاية القول في الأبواب المختصة بذكر الأحكام البلاغية التي تعرض للمفردات في حال تركيبها. ومن الأحكام ما هو عارض للجمل المؤتلف منها الكلام البليغ تفريقا وجمعا وتطويلا واختصارا. وقد خص لذلك بابان: باب الوصل والفصل وباب الإيجاز والإطناب والمساواة. وها انذا شارع فيهما إكمالا لأبواب علم المعاني.
�الوصل والفصل
الوصل عطف بعض الجمل على بعض والفصل تركه. وحق الجمل إذا ذكر بعضها بعد بعض أن تذكر بدون عطف لأن كل جملة كلام مستقل بالفائدة إلا أن أسلوب الكلام العربي غلب فيه أن يكون متصلا بعضه ببعض بمعمولية العوامل والأدوات أو بالإتباع أو بالعطف() فلا تذكر جمل الكلام ولا كلماته تعدادا إلا في الواقع التي يقصد فيها التعداد نحو قوله(( فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة)) أو في حكاية المحاورات نحو(( قالوا سلاما قال سلام)) وقولنا سئل فلان أجاب() أو إملاء الحسبان نحو واحد اثنان أو قصد إظهار انفصال الجمل واستقلالها كقوله تعالى(( إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون)).
أو في مواقع الفصل الآتية:
فعطف الجمل إما بالواو المقتضية لأصل التشريك في الحكم المتكلم فيه. وإما بحرف آخر يدل على معنى زائد على التشريك أو على ضد التشريك إذا وجد معنى ذلك الحرف نحو الفاء وحتى و أو وبل.
وهذا الأصل الذي أشرت إليه يعدل عنه لأحد أمرين: لمانع يمنع منه أو لشيء يغني عنه.
ثم شرط صحة العطف مطلقا في المفردات والجمل وبالواو وبغيرها وجود المناسبة التي تجمع الجملة المعطوفة والجملة المعطوفة عليها في تعقل العقول المنتظمة بحسب المتعارف () عند المتكلمين بتلك اللغة.
وهاته المناسبة لا تعدو التماثل أو التضاد أو القرب من أحدها نحو زيد يكتب ويشعر. (( والسماء رفعها)) إلى قوله(( والأرض وضعها للأنام)) () بخلاف نحو زيد يكتب وينام.ويعطي وينظم الشعر.وخرجت من السوق وأبدع امرؤ القيس في شعره.وإن كان كل ذلك كلاما صادقا حتى كان العطف في المقام الذي لا توجد فيه المناسبة مؤذنا بمقصد كمقصد التشبيه في قول كعب ((أن ألاماني والأحلام تضليل)).فإن الكلام على مواعيد سعاد وأمانيها ولا كلام على الأحلام فلما عطف الأحلام على الأماني علمنا أنه قصد تشبيه أمانيه الناشئة عن دعواها بالأحلام في اللذاذة وعدم التحقق.
وهذا وجه الاحتراز فيما مضى بقولي ((المنتظمة بحسب المتعارف)) وقد يكون التناسب موهوما ومجرد دعوى في المقامات الشعرية واللطائف كقوله:
ثلاثة تشرق الدنيا ببهجتها
شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر
وقد يكون التناسب غريباً نابعاً لتناسب شيئين آخرين كقوله تعالى: ((والنجم والشجر يسجدان)) فإن التناسب أوجده ما يأتي بعده من قوله ((والسماء رفعها)) وقوله ((والأرض وضعها)) لأن النجم من توابع السماء والشجر من توابع الأرض ثم يكفي في هذه المناسبة التقارن في الغرض المسوق له الكلام.
ولهذا كان العطف بالفاء وثم وحتى أوسع في هذه المناسبة المشروطة، لأن الترتب أو المهلة أو الغاية كلها مناسبات كافية لتصحيح العطف لأنها دالة على التقارن في الوجود.
وهذا التقارن مهيء للمناسبة ومسوغ للعطف لكنه يزداد حسناً إذا قوي التناسب ولذا كان أصل الفاء التفريع ما لم تبعد المناسبة، ألا ترى كيف حسن العطف في قول عمرو بن كلثوم:
نزلتم منزل الأضياف منا
فعجلنا القرى أن تشتمونا()
وكيف يقبح العطف بالفاء لو قلت جاء زيد فصفعوه ويزيد قبحاً لو قلت جاء زيد فنهق الحمار لبعد المناسبة() وكيف يحسن أن تقول طلع الفجر فأذن المؤذن.
وقول ابن زمرك:
هبَّ النسيم على الرياض مع السحر
فاستيقظت في الدوح أجفان الزهر
ويكون دونه حسناً -طلع الفجر فصاح الديك- وكيف يقبح أن تقول طلع الفجر فاستيقظ زيد إذا لم يكن الحديث قبل ذلك على زيد.
إذا تحققت هذا فاعلم أنه يتعين الوصل إذا أريد تشريك الجملة المعطوفة للجملة المعطوف عليها في حكمها في الإعراب كعطف الجمل المعمولة لعامل واحد بعضها على بعض() أو التشريك في حكمها في المعنى وإن لم يكن للمعطوف عليها محل من الإعراب.
والمراد من الحكم الكيفية الثابتة لمفهوم الجملة المعطوف عليها مثل حكم القصر في قوله تعالى: ((إنما أنت منذر ولكل قوم هاد)) فقد عطف جملة ((ولكل قوم هاد)) على جملة إنما أنت منذر لأن المقصود تشريكها في حكم القصر، إذ المقصود من الجملتين الرد على من اعتقد خلاف ذلك() وليس للجملتين محل من الإعراب.
ويتعين الفصل إذا أريد التنبيه على أن الجملة الثانية منقطعة عن الأولى أي غير مشاركة لها لا في الحكم الإعرابي نحو قوله تعالى: ((قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزءون الله يستهزئ بهم)) لم تعطف جملة ((الله يستهزئ بهم)) لئلا يظن السامع إنها من قولهم، ولا في مجرد الحكم المعنوي حيث لم يكن إعراب نحو قوله تعالى: ((إنما أنت منذر ولكل قوم هاد * الله يعلم ما تحمل كل أنثى)) لم تعطف جملة الله يعلم لأنه لم يقصد دخولها في حكم القصر إذ لا قصد للرد على معتقد أن الله لا يعلم ما تحمل كل أنثى إذ لم يكن في المخاطبين من المشركين وأهل الكتاب من يعتقد ذلك، وكذا قولهم -مات فلان رحمه الله- فلو عطف -رحمه الله- لظن أن الجملة الدعائية أخبار عن فعل الله معه.
فالفصل في هاته الأمثلة كلها لأجل انقطاع الجملتين بعضهما عن بعض كما رأيت.
ويتعين الفضل أيضاً إذا كانت الجملة الثانية عين الأولى في المعنى أو في محصل الفائدة لأن العطف يقتضي المغايرة: فالتي هي عين الأولى في المعنى نحو قول الشاعر الذي لم يعرف:
أقول له راحل لا تقيمن عندنا
وإلا فكن في الجهر والسر مسلما
فإن معنى لا تقيمن هو ما يفيده معنى قوله ارحل، فكانت الجملة الثانية كبدل الاشتمال من الأولى() والتي هي عين الأولى في محصل الفائدة مثل المؤكدة نحو ((ذلك الكتاب لا ريب فيه)) فجملة لا ريب فيه مؤكدة لمعنى ذلك الكتاب.
ومن أنواع الوصل عطف طائفة من الجمل على مجموع طائفة أخرى بحيث تعطف قصة على قصة أو غرض على غرض في الكلام فلا تلاحظ إلا المناسبة بين القصة والقصة والغرض والغرض لا بين أجزاء كل من القصتين حتى إذا وليت الجملة الأولى من القصة المعطوفة إحدى جمل القصة المعطوف عليها لا يتطلب وجه لتلك الموالاة لأنها موالاة عارضة، وهذا نحو عطف قوله تعالى: ((وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات)) إلخ، على قوله تعالى ((وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا)) لأن قوله -وإن كنتم في ريب- مسوق لبيان عقاب الكافرين وقوله -وبشر- مسوق لبيان ثواب المؤمنين، ونظيره من عطف المفردات قوله تعالى: ((هو الأول والآخر والظاهر والباطن)) فإنه لو قصد عطف الظاهر على الآخر لم يحسن وإنما القصد عطف وصفين متقابلين على وصفين متقابلين وكلها لموصوف واحد.
عطف الإنشاء على الخبر وعكسه منع بعض علماء العربية عطف الإنشاء على الخبر وعطف الخبر على الإنشاء والحق أن ذلك ليس بممنوع وهو كثير في الكلام البليغ وقد قال الله تعالى: ((واذكر عبدنا داوود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب)) عطف -وهل أتاك- على -أخبار داوود-.
واعلم أنه قد يخالف الظاهر فيؤتى بالوصل في مقام الفصل وبعكسه لقصد دفع إيهام ينشأ عن ارتكاب مقتضى الظاهر كما جاء الفصل في قول الشاعر الذي لم يعرف:
وتظن سلمى أنني أبغي بها
بدلاً أراها في الضلال تهيم
كان الظاهر عطف جملة -أراها- لكنه فصلها لئلا يتوهم السامع أن ذلك ممات ظنه سلمى فالوصل سبب منع منه مانع.
وكما جاء الوصل في نحو قولهم (لا وأيدك الله)) فإن الظاهر الفصل لأن الجملتين غير مشتركتين في الحكم() ضرورة أن أحدهما خبر والأخرى إنشاء فقد وجد مانع الوصل ولكنه خلفه مقتض إذ لو فصل لتوهم الدعاء بنفي تأييده.
هذه معاقد أحوال الفصل والوصل وفي وجوه الاتصال والانفصال المرتب عليهما الوصل والفصل تفاصيل واعتبارات دقيقة يجب إرجاؤها لكتب مرتبة أرقى من هذه().

|
| |
|
|