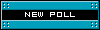| thesilentlover1 | التاريخ: الأحد, 2012-04-01, 0:41 AM | رسالة # 1 |
 القائد العام
مجموعة: المدراء
رسائل: 312
حالة: Offline
|
موجز البلاغة
للعلامة الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور
قام بصف الكتاب
أبو عمر آل عبدالمنعم
بناء على طلب شيخه
عبدالرحمن الكوني�تقريض الكتاب
بقلم العلامة الجليل الأستاذ الأكبر الهمام مولانا الشيخ سيدي محمد بن يوسف شيخ الإسلام الحنفي أبقى الله النفع به.
حمداً لمن نظم جواهر البلاغة بأسلاك البيان، وألهم كل بليغ لمقتضى الحال والشان، وأكرم من شاء بفضيلة الإحسان، والكلم الحسان، وصلاة وسلاماً على سيدنا ومولانا محمد أفصح من نطق بالضاد من بني معد وعدنان، المؤيد بالقرآن، الذي أعجز مصانع البلغاء من قاص ودان، فلم يكن لهم في معارضته يدان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الفصحاء الجلة الأعيان، وبعد فقد أجلت النظر في غضون هذه الرسالة الوجيزة، والدرة الثمينة العزيزة، فوقفت منها على روضة زاهرة زاهية، قطوفها دانية لا تسمع فيها لاغية، فيها من تقريب العبارة، وتوضيح الإشارة، ما تتلقاه المدركة بمجرد الالتفات، ولا تخشى فيه الحافظة الفوات، معززة القواعد بمختارات الشواهد، وفرائد الفوائد، إلى اعتبارات لطيفة، وتحقيقات شريفة، وأنها لتبصرة للناشئين، وتذكرة للشادين والمتبصرين، جديرة بالتخصيص، لأن تكون مبدأ لدراسة التلخيص، حسنة من حسنات ذلك الهمام ناشراً لوية العلوم، وكشاف غوامض المفهوم، مدبج صفحات المهارق ببدائع التحبير والتحرير، العلامة الجهبذ الأستاذ الدراكة النحرير، صفوة الخيرة أبي عبد الله الشيخ سيدي محمد الطاهر ابن عاشور شيخ الإسلام المالكي أدام الله فضله، وكم له في الفنون من يد حميدة، ومصنفات رائقة مفيدة، متع الله الأمة بمواهبه العلمية، ومحرراته العبقرية، بمنه تعالى وكرمه كتبه الفقير إلى ربه محمد بن يوسف شيخ الإسلام الحنفي لطف الله به في 12 ربيع الثاني سنة إحدى وخمسين وثلاثمائة وألف.
�قرار النظارة العلمية
الحمد لله أما بعد فقد قررت النظارة العلمية تدريس موجز علم البلاغة لأهل السنة الأولى في المرتبة المتوسطة عوضاً عن رسالة الوضع وكتب في 10 جمادى الأولى وفي 10 سبتمبر سنة 1351 – 1932.
محمد بن يوسف، محمد الطاهر ابن عاشور، محمد الطيب بيرم، صالح المالقي.
�بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه
هذا موجز علم البلاغة
أما بعد حمداً لله الذي أنطق البلغاء وفضّل النبغاء، وميزهم عمن يُسِرُّ حَسْوًا في ارتغاء، والصلاة والسلام على المرسل بالحنيفية لا أمت فيها ولا شُغَاء، وكل من صغى إلى دعوته أفضل صغاء، فإني رأيت طلبة العلم يزاولون علم البلاغة بطريقة بعيدة عن الإيفاء بالمقصود إذ يبتدؤون بمزاولة رسالة الاستعارات لأبي القاسم الليثي السمرقندي وهي زبدة مستخلصة من تحقيقات المطول والمفتاح يحتسونها قبل إبانها ثم يتناولون مختصر التفتازاني قبل أن يأخذوا شيئا من علم المعاني وفي ابتدائهم شوط وفي انتقالهم طفرة فرأيت أن أضع لهم مختصراً وجيزاً يلم بمهمات علم البلاغة ليكون لهم كالمقدمة لمزاولة دروس مختصر التفتازاني وضعته وضع من يقصد إلى تثقيف طلبة هذا العلم بالمسائل النافعة المجردة عن المباحث الطفيفة في فنون البلاغة الثلاثة فإن هم أتقنوه فهماً ضمنت لهم أن ينطقوا بلسان فصيح، ويملأوا أوطاب أذهانهم من المحض الصريح.
�مقدمة
البلاغة فعالة مصدر بلُغ بضم اللام كفقه وهو مشتق من بلَغ بفتح اللام بلوغاً بمعنى وصل وإنما سمي هذا العلم بالبلاغة لأنه بمسائله وبمعرفتها يبلغ المتكلم إلى الإفصاح عن جميع مراده بكلام سهل وواضح ومشتمل على ما يعين على قبول السامع له ونفوذه في نفسه فلما صار هذا البلوغ المعنوي سجية يحاول تحصيلها بهذا العلم صاغوا له وزن فعُل بضم العين للدلالة على السجية فقالوا علم البلاغة () فإن المتكلم إذا تكلم فإنما اهتمامه بأن ينقل ما في ضميره إلى ذهن سامعه فهو محتاج قبل كل شيء إلى معرفة اللغة التي يريد أن يخاطب بها من مفرداتها وكيفية تركيبها فإذا لم يعلم ذلك لم يكد كلامه أن يفهم وهذه المعرفة تحصل له من علم اللغة والنحو والصرف فإن حاول تكلمها بدون هذه المعرفة كان مثله كما قال الحطيئة في الشعر ((يريد أن يعربه فيعجبه))() ولكنه إذا علم اللغة والنحو والصرف فإنما يستطيع أن يعبر عن حاصل المراد وأصل المعنى ولا يستطيع أن يفصح عن تمام المراد فلو أراد أن يخبرك بحضور تلميذ واحد من تلامذة درسه وتخلف الباقين فقال لك حضر زياد لم تفهم إلا أنه أخبرك بحضور زياد لئلا تكتبه متخلفاً ثم إذا علمت أن بقية التلامذة لم يحضروا فقلت له: ما بالك لم تخبرني بعدم حضور أنس ونافع وغيرهما؟ قال لك: ألستُ قد أخبرتك بحضور زياد ولم أذكر لك غيره؟ فدلك بقوله ذلك على قصوره في معرفة أداء جميع مراده على أنه لو تنبه لزيادة البيان لقال حضر زياد ولم يحضر أنس لم يحضر نافع لم يحضر زهير وأخذ يعدد بقية التلامذة أو استعان بحركة يديه فقال لك حضر زياد ثم ضرب بيديه كالنافض لهما كأنه يشير إلى معنى فقط فحينئذ أدى جميع مراده لكن بعبارة غير سهلة ومع إشارة فإذا كان قد علم الكيفية الخصوصية للتعبير عن هذا المراد وهي أن يقول ما حضر إلا زياد كان قد بلغ إلى أداء جميع مراده بكلام سهل وكذا إذا أراد أن يخبرك عما أبلاه عنترة من الشجاعة والفتك في يوم من أيامه فجعل يقول قتل فلاناً وجرح فلاناً وضرب فلاناً وضرب الفرس فأدماه وهرب راكبه وسبى نساءهم وحطم مشاتهم فإنه قد دلك على جميع مراده بعبارة غير واضحة في الدلالة على جميع المراد بكلام واضح الدلالة عليه، ولما كانت الكيفيات المذكورة لا تقع إلا في كلام خاصة أهل اللسان العربي سموها بالخصوصيات نسبة إلى الخصوص وهو ضد العموم الذي هو بمعنى الجمهور وتسمى بالنكت أيضاً.
فالعلم الباحث عن القواعد التي تصير الكلام دالاً على جميع المراد وواضح الدلالة عليه يدعى علم البلاغة، ثم إن هنالك محسنات للكلام متى اشتمل عليها اكتسب قبولاً عند سامعه ولما كان حسن القبول يبعث السامع على الإقبال على الكلام بشراشره وكان في ذلك عون على إيعاء جميع المراد جعلوا تلك المحسنات اللفظية من لواحق مسائل هذا العلم سواء كان حسنها عارضاً للفظ من جهة موقعه المعنوي() كالمطابقة في قول أبي ذؤيب الهذلي:
أما والذي أبكى وأضحك والذي
أمات وأحيى والذي أمره الأمر
أم كان حسنها عارضاً له من جهة تركيب حروفه كالجناس في قول الحريري:
سِمْ سِمَةً تحمد آثارها
واشكر لمن أعطى ولو سِمْسِمَة
فكلها تسمى المحسنات وتوابع البلاغة ويلقبونها بالبديع.
فانحصر على البلاغة لذلك في ثلاثة فنون فن المعاني وهو المسائل التي بمعرفتها يستطيع المتكلم أن يعبر عن جميع مراده بكلام خاص، وسمي علم المعاني لأن مسائله تعلمك كيف تفيد معاني كثيرة في ألفاظ قليلة، أما بزيادة لفظ قليل يدل على معنى حقه أن يؤدى بجمل مثل صيغة إنما في الحصر، وكلمة إن في التأكيد ورد الإنكار معاً وأما بأن لا يزيد شيئاً ولكنه يرتب الكلام على كيفية تؤدي بذلك الترتيب معنى زائداً مثل تقديم المفعول والظرف لإفادة الحصر في نحو: الله أحد، وإياك نعبد وهذا الفن هو معظم علم البلاغة، وفن البيان وهو المسائل التي بمعرفتها يعرف وضوح الدلالة على المراد كقولك: عنترة أسد، وحاتم كثير الرماد، وفن البديع وهو المسائل التي تبحث عن المحسنات اللفظية كما تقدم.
فتعريف علم البلاغة هو العلم بالقواعد التي بها يعرف أداء جميع التراكيب حقها وإيراد أنواع الشبيه والمجاز والكناية على وجهها وإيداع المحسنات بلا كلفة مع فصاحة الكلام.
(تاريخه) كان هذا العلم منثوراً في كتب تفسير القرآن عند بيان إعجازه وفي كتب شرح الشعر ونقده ومحاضرات الأدباء من أثناء القرن الثاني من الهجرة فألف أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 144 كتاب مجاز القرآن وألف الجاحظ عمر وبن بحر المتوفى سنة 344 كتباً كثيرة في الأدب وكان بعض من هذا العلم منثوراً أيضاً في كتب النحو مثل كتاب سيبويه ولم يخص بالتأليف إلا في أواخر القرن الثالث إذا ألف عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي (المولود سنة247 والمتوفى سنة296 قتيلاً بعد أن بويع له بالخلافة ومكث يوما واحداً خليفة) كتاب البديع أودعه سبعة عشر نوعاً وعد الاستعارة منها).
ثم جاء الشيخ عبد القاهر الجرجاني الأشعري الشافعي المتوفى سنة 471 فألف كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة أولهما في علم المعاني والثاني في علم البيان فكانا أول كتابين ميزا هذا العلم عن غيره ولكنهما كانا غير ملخصين ولا تامي الترتيب فهما مثل در متناثر كنزه صاحبه لينظم منه عقداً عند تأخيه فانبرى سراج الدين يوسف بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي المعتزلي المولود سنة 555 والمتوفي سنة 626 إلى نظم تلك الدرر فألف كتابه العجيب المسمى مفتاح العلوم في علوم العربية وأودع القسم الثالث منه الذي هو المقصود من التأليف مسائل البلاغة دونها على طريقة علمية صالحة للتدريس والضبط فكان الكتاب الوحيد اقتبسه من كتابي الشيخ عبد القاهر ومن مسائل الكشاف في تفسير القرآن للزمخشري فأصبح عمدة الطالبين لهذا العلم وتتابع الأدباء بعده في التأليف في هذا العلم الجليل.
�فن المعاني
المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يكون بليغاً فصيحاً في أفراده وتركيبه() فالفصاحة أن يكون الكلام خالصاً أي سالماً مما يعد عيباً في اللغة بأن يسلم من عيوب تعرض للكلمات التي تركب منها الكلام أو تعرض لمجموع الكلام() فالعيوب العارضة للكلمات ثلاثة الغرابة، وتنافر الحروف، ومخالفة قياس التصريف، والعيوب العارضة لمجموع الكلام ثلاثة التعقيد () وتنافر الكلمات، ومخالفة قواعد النحو ويسمى ضعف التأليف.
أما الغرابة فهي قلة استعمال الكلمة في متعارف أهل اللغة أو تناسيها في متعارف الأدباء مثل الساهور اسم الهلال ومثل تكأكأ بمعنى اجتمع وافر نقع بمعنى تفرق في قول أبي علقمة أحد الموسوسين وقد أصابه صرع فأحاطت به الناس (( مالكم تكأكأتم علي كما تكأكأون على ذي جنة افر نقعوا))() وأما تنافر الحروف فهو ثقل قوي في النطق بالكلمة لاجتماع حروف فيها يحصل من اجتماعها ثقل نحو الخعخع نبت ترعاه الإبل وأقل منه في الثقل مستشزرات بمعنى مرتفعات وأما الثقل الذي لا يضجر اللسان فلا يضر نحو وسبحه وقول زهير * ومن هاب أسباب المنايا ينلنه*
وأما مخالفة قياس التصريف فهو النطق بالكلمة على خلاف قواعد الصرف.
كما يقول في الفعل الماضي من البيع بَيَعَ لجهله بأن حرف العلة إذا تحرك وانفتح ما قبله يقلب ألفا.
وأما التعقيد فهو عدم ظهور دلالة الكلام على المراد لاختلال في نظمه ولو كان ذلك الاختلال حاصلا من مجموع أمور جائزة في النحو كقول الفرزدق يمدح إبراهيم بن هشام المخزومي خال الخليفة هشام بن عبد الملك
وما مثله في الناس إلا مملكا
أبو أمه حي أبوه يقاربه
أراد وما مثله في الناس حي يقاربه أي في المجد إلا ملكاً أبو أم الملك أبو هذا الممدوح فشتت أوصال الكلام تشتيتاً تضل فيه الأفهام() وأما التنافر فهو ثقل الكلمات عند اجتماعها حين تجتمع حروف يعسر النطق بها نحو قول الراجز الذي لا يعرف.
وقبر حرب بمكان قفر
وليس قرب قبر حرب قبر
فكل كلمة منه لا تنافر فيها وإنما حصل التنافر من اجتماعها حتى قيل إنه لا يتهيأ لأحد أن ينشد النصف الآخر ثلاث مرات متواليات فلا يتلعثم لسانه.
وأما مخالفة قياس النحو فهو عيب كبير لأنه يصير الكلام مخالفاً لاستعمالات العرب الفصحاء فهو يعرض للمولدين والمراد منه مخالفة ما أجمع النحاة على منعه أو ما كان القول بجوازه ضعيفاً ووروده في كلام الغرب شاذاً نحو تعريف غير في كقول كثير من طلبة العلم الغير كذا ونحو تقديم التأكيد على المؤكد في قول المعري
تعب كلها الحياة فما أعــ
ـجب إلا من طامع في ازدياد
وكذلك كل ما جوزه في ضرورة الشعر إذا وقع شيء منه في النثر فضعف التأليف عيب لا يوجب إنبهام المعنى بخلاف التعقيد.
والبلاغة اشتمال الكلام على أحواله خصوصية() تستفاد بها معان زائدة على أصل المعنى() بشرط فصاحته كاشتمال قوله تعالى: ((فقالوا إنا إليكم مرسلون)) على حالة خصوصية وهي التأكيد بأن لإفادة معنى زائد وهو توكيد الخبر لأجل إبطال تردد المخاطبين فيه وذلك أمر زائد على أصل المعنى وهو الإعلام بكونهم رسلاً الذي يكفي لإفادته أن يقال أرسلنا إليكم أو نحن إليكم مرسلون وتسمى هذه الأحوال الخصوصية بالنكت وبالخصوصيات وهي تكثر وتقل في الكلام بحسب وجود الدواعي والمقتضيات من كثرة وقلة كالأدوية فإنها تشتمل على عقاقير كثيرة تارة وقليلة أخرى بحسب ما يحتاجه المزاج لإصلاحه، انظر مثلاُ قوله تعالى: ((هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور)) فنجد في قوله ((ينزل)) خصوصيتين: إحداهما التعبير بصيغة ((فعَّل)) الدالة على التكرير، والثانية التعبير بصيغة المضارع الدالة على التجدد والاستمرار لأن المقام للتبشير بزيادة الإخراج من الظلمات إلى النور يوماً فيوماً وفي كل حال، وانظر قوله في الآية الأخرى ((نزل عليك الكتاب بالحق)) فلا تجد في ((نزل)) إلا خصوصية واحدة وهي التعبير بصيغة (فعل) لأن المقام للامتنان، والامتنان يكون بما وقع لا بما سيقع والبليغ في إتيانه بهذه الأحوال في كلامه يراعي أحوال المخاطبين ومقامات الكلام() فلا يأتي بنكتة وخصوصية إلا إذا رأى أن قد اقتضاها حال المخاطب واستدعاها مقام الكلام وبمقدار تفاوت المتكلمين في تنزيلها على مواقعها يتفاوت الكلام في مراتب البلاغة إلى أن يصل إلى حد الإعجاز الذي يعجز البشر عن الإتيان بمثله وهو الذي اختص به نوابغ بلغاء العرب مثل امرئ القيس والنابغة والأعشى وسحبان في أكثر كلامهم.
وحيث كانت البلاغة يتصف بها الكلام باعتبار إفادته عند التركيب والإسناد فلا جرم إن كان ملاك الأمر فيها راجعاً إلى ما يتقوم به الإسناد وكذلك كيفيات الإسناد والمسند إليه والمسند ثم تتفرع البلاغة في متعلقاتها من المعمولات أحوال الجمل وسيجيء كل نوع من ذلك في بابه.
باب الإسناد
الإسناد ضم كلمة إلى أخرى ضما يفيد ثبوت مفهوم أحداهما لمفهوم الأخرى نحو حاتم كريم وأكرم حاتماً، أو انتفاءه عنه نحو ما خالد جباناً ولا تقاتل خالداً سواء كان بالتعيين أم بالترديد().
وحكم ما يجري مجرى الكلمة نحو الضمير المستتر والجملة الواقعة خبراً حكم الكلمة() فالكلمة الدالة على المحكوم عليه ما تسمى مسنداً إليه والكلمة الدالة على المحكوم به تسمى مسنداً والحكم الحاصل من ذلك يسمى الإسناد ولكل من المسند إليه والمسند والإسناد عوارض بلاغية تختص به.

|
| |
| |